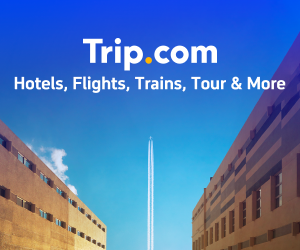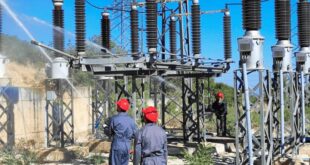#أشكال #السيطرة #السياسية #عبد #الإله #بلقزيز
إنْ أخذنا التّسلّط بمعنى الغُلوِّ في ممارسة السّلطة ومجاوزةِ حدودها إلى حالٍ من الاشتطاط غيرِ مقبولةٍ ولا مشروعة، أمكن القول إنّه كثيراً ما تبدّى في السّياسة وتاريخ السّياسة على أنحاء مختلفة وفي صُوَرِ متعدّدة في أحقاب عديدة من تجارب الدّول، وكثيراً ما آذى المجتمعات التي وقع عليها الإيذاءَ الشّديد، فسَامَ النّاس خسفاً، وعطّل حركة التّطوّر والتّقدّم فيها، وقَمَع الفكر ووَأَدَ الاجتهاد، وأحدثتْ قسوتُه من الحنق والاضطراب والثّوران، في عموم النّاس، ما انتقضتْ به الأحوالُ واهتزّ به الاستقرارُ، وأحياناً، إلى حدود إضعاف الممالك التي استوطنها ذلك التّسلّط وإيهانِ قوّتها وشوكتها على نحوٍ هيّأها لأن تَسْقُط، بيُسْرٍ شديد، في وجه طالبيها من الغزاة الخارجيّين. ومع أنّ مضمون التّسلّط السّياسيّ واحد، في كلّ مكانٍ وزمان، ومفاعيلُه متشابهة في إتيانها على المجتمعات والدّول بوخيم العقابيل، إلاّ أنّه خَضَع – مع ذلك – لتطوّرٍ دائبٍ في آليات فعْلِه كما في تكوينه الأمر الذي نَجَم منه ميلادُ نماذجَ متعدّدة منه تقرّرت تبعاً للشّروط التي أنجبتْها.من النّافل القول إنّ تطوُّر نظام التّسلّط السّياسيّ وتدرُّجَه في الحدّة، وتعدُّدَ تبدّياته وأشكالِه ليس شيئاً آخر سوى تطوّر السّياسة وأنظمة الحكم في الدّول، وما طرأ على تلك الأنظمة – ويطرأ – من تبدُّلٍ في نماذج تكوينها وأنماط اشتغالها. ليس في هذا وجْهُ غرابة، ذلك أنّ كلّ تأْريخٍ لظاهرة التّسلّط السّياسيّ سيمُرّ، حُكْماً، بتأْريخٍ لنطاقه الذي يقع فيه: أعني السّياسةَ والدّولَ المتعاقبة التي تتجسَّد فيها تلك السّياسةُ واقعاً مادّيّاً، ثمّ بتأْريخٍ للصّوَر أو الأشكال التي يتبدّى فيها ذلك التّسلّط، في هذه الدّولة وفي تلك، وفي هذه الحقبة من التّاريخ وتلك، أي أنّه يسلك لنفسه – بالضّرورة – سبيلَ مطالعة سياقات تطوّر ظاهرة السّياسة في التّاريخ، وعلى نحوٍ خاصّ ظاهرة السّلطة بحسبانها الفضاء الذي يتحقّق فيه فعْلُ السّياسة ويُفْصِح عن مضمونه فيسمح، بالتّالي، بقياس مدى مشروعيّة السّلطة القائمة أو مدى انزياحها عن شرائط المقبوليّة المجتمعيّة. ما كان غريباً، إذن، أن تكون الفلسفة أكثر الميادين هجْساً بالسّياسة والسّلطة في تاريخ الفكر، فلقد انفردت عن سواها من ميادين الفكر الأخرى بامتلاكها الأدوات المفهوميّةَ المناسبة لتناوُل ظاهرة السّياسة والسّلطة، في المجتمعات الإنسانيّة، ولتصنيفها إلى أنماطٍ وفئاتٍ بناءً على مبادئَ وقواعدَ تُحدِّدها ووفقاً لسُلّمٍ تراتبيّ تتفاضل فيه تلك الأنماط.ميّزَ الفلاسفة الإغريق، منذ سقراط، نظامَ التّسلّط السّياسيّ وحدّدوا أسسَه ومواصفاته ووجوهَ اختلافه عن سواهُ من أنظمة الحكم بدقّةٍ شديدة. لقد أخذ التّسلّط في السّياق اليونانيّ، إذن، شكلاً بعينه هو الطّغيان، ولعلّه لم يبارح هذا المعنى الحصريّ، في تاريخ الفكر السّياسيّ، إلاّ في النّادر من الأحوال.قد يكون نظامُ الحكم نظامَ قلّةٍ أو نخبةٍ لا نظامَ فرد، لكنّ ذلك لا يغيّر شيئاً من كونه قد يجري أمرُهُ إمّا على منوالٍ تسلّطيّ أو على منوالٍ نقيض نظيرَ ما يجري على نظام الفرد: بحسب تمييز أرسطو. قد يكون نظامَ عصبيّةٍ أهليّة، على مثال ذلك الذي حلّله عبد الرّحمن بن خلدون، وعَدَّه النّظامَ الأساس في تاريخ الاجتماع الإسلاميّ. ومع أنّ النّظام الذي من هذا الجنسِ مبناهُ على عصبيّةٍ واحدة غالب، إلاّ أنّه قد يكون في بعض أطواره (الأولى منها حسب ابن خلدون) صالحاً أو مقبولاً من العصبيّات الأخرى التي التحمت به وتحقّقت له الغلبةُ بالتحامها. هكذا يكون اجتماعُ العصائب على المصلحة العامّة الجامعة سبباً لشرعنة هذا النّظام والنّظرِ إليه بما هو تشاركيّ، فيما يأتي ميْلُ العصبيّة الكبرى الغالبة فيه إلى إقصاء باقي العصائب والاستبداد بالحكم، خدمةً لمصلحتها الخاصّة هي وحدها، سبباً لانقلاب ذلك الاستبداد من استبداد حلفِ عصبيّاتٍ إلى استبدادِ واحدةٍ منها وبالتّالي، إلى احتكارٍ كاملٍ للسّلطة وجنوحٍ حادٍّ للتّسلّط.كما قد يكون نظامُ القلّةِ نظامَ طبقةٍ اجتماعيّة، على مثال ما حلّل ماركس ذلك في المجتمعات البرجوازيّة الحديثة، أو نظام أوليغارشيّة عسكريّة، نظير ذلك النّظام الذي قام في بلدان أمريكا اللاّتينيّة وتسلّطت فيه فاشيّات عسكريّة، كما قد يكون نظاماً للحزب الواحد الذي يستبدّ بالسّلطة، على نحو ما رأينا نموذجه في بلدان المعسكر «الاشتراكيّ» سابقاً ونظائرها في العالم. على أنّ النّظام الذي مبناهُ على هذه القِلّة الاجتماعيّة قد يكون نظاماً للتّسلّط السّياسيّ سالكاً فيه مسْلَك الطّغيان والقهر واحتكار السّياسة، كما قد يكون عكس ذلك نظاماً ذا مشروعٍ سياسيّ عميمِ الفائدة على المجتمع وطبقاته كافّة.هكذا، مثلاً، تَصَوَّر ماركس أنّ سلطة الپروليتاريا لا تخدم مصالح طبقة العمّال حصراً – كما تخدم سلطة البرجوازيّة طبقة البرجوازيّة حصراً – بل مصالح طبقات الشّعب كافّة. وهكذا كشفت تجارب أنظمة الحزب الواحد أنّ بعضَها لم ينصرف إلى توطيد مصالح قوى حزبه فقط، بل إلى خدمة المصالح العامّة. على أنّه إذا كانت تجارب سلطة القِلّة، في حالتيْها الطّبقيّة والحزبيّة، قد انطوت على حقيقتيْن فيها متناقضتين هما: التّسلّط وتعظيم المصلحة العامّة، فإنّ سلطة الأوليغارشيّات – وخاصّةً تلك التي تأخذ شكلَ طغمة عسكريّة فاشيّة – لا يمكنها أن تفصح سوى عن جوهرها التّسلّطي في الأحوال جميعِها من غير أن تقدِّم خدمةً للمجتمع تعادل ما تأخذه منها بتسلُّطها وفسادها. [email protected]


 كيتا بوست Keta Post | كيتا بوست هو موقع إلكتروني إخباري شامل يقدم محتوى متنوعًا يغطي الأخبار، الخدمات، الرياضة، الثقافة، والتعليم. يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور العربي، مع الالتزام بالمهنية والحيادية في نقل الأحداث.
كيتا بوست Keta Post | كيتا بوست هو موقع إلكتروني إخباري شامل يقدم محتوى متنوعًا يغطي الأخبار، الخدمات، الرياضة، الثقافة، والتعليم. يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور العربي، مع الالتزام بالمهنية والحيادية في نقل الأحداث.